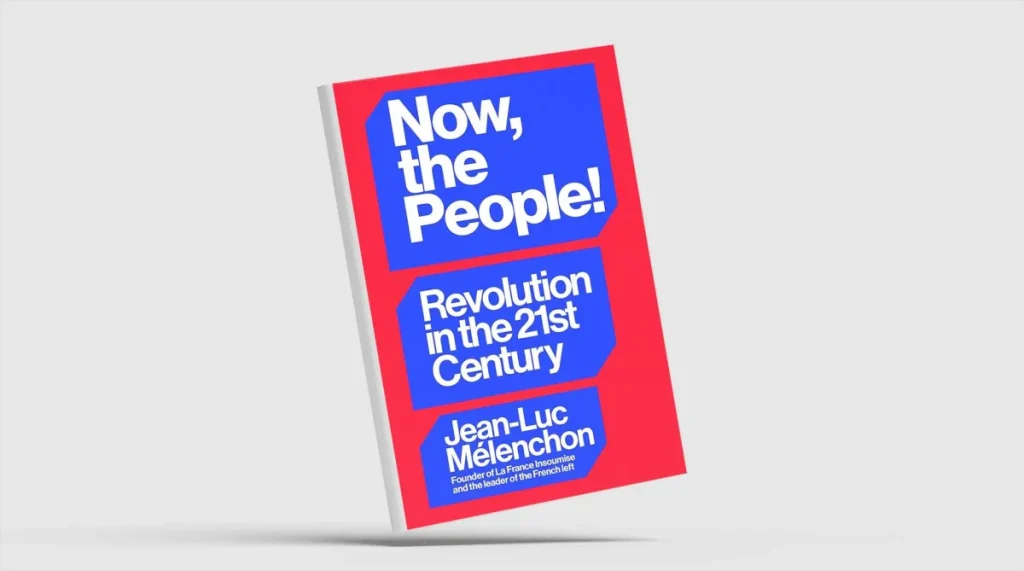بين الصورة والحرف المطبوع… هل هناك مستقبل للرواية؟
لم تولد السينما إلا من رحم الرواية التي كان قد مضى على ظهورها نحو 3 قرون، إذا عددنا ملحمة «دون كيشوت» الساخرة لسيرفانتس الصادرة عام 1615 بداية انطلاق هذا النوع الأدبي الجديد.
لقد أسس الروائيون الكبار خلال القرن التاسع عشر على الخصوص ما يمكن تسميته المشهد الروائي، حيث يتحدد المكان والزمان اللذان تدور فيهما أحداث الرواية بدقة، وبالطبع كان الروائي يقوم بتقديم كل التفاصيل التي يتطلبها المشهد من ديكور إلى ملابس إلى طقس إلى تحديد الوقت، إلخ… بالمقابل، فإنه اعتمد على مخيلة القارئ بقدرتها على تحويل الكلمات إلى مشهد يراه في عين العقل. وكما يقول الفيلسوف الألماني شوبنهاور ما معناه: «نحن نفهم أي فكرة بتحويلها إلى صورة»، وإذا طبقنا فكرته على الرواية فإن كلمات أي فقرة في الرواية سواء أكانت فكرة أو وصفاً، أو حواراً، تتحول إلى سلسلة من الصور في أذهاننا وهذه هي الطريقة التي تجعلنا نستوعب هذه الفقرة، وكأنها جزء من حقيقة نجحت الرواية في إيهامنا يها.
وإذا كان المخرجون السينمائيون الرواد قد استندوا إلى هذا الإرث الكبير الذي أبدعه أسلافهم الروائيون في صياغة الحبكة والمشهد والحوارات وغيرها، فإنهم إضافة إلى ذلك، اعتمدوا على الموروث الروائي الكبير في إنتاج أفلامهم، وهكذا أصبحت روايات مثل «سندريللا» (1897) و«الملك جون» (1899) لجورج ميلييز (1899) و«فرانكشتاين» (1910) لماري شيلي (1910) من أوائل الأعمال التي اقتبسها المخرجون الأوائل لأفلامهم السينمائية، وفيها اتبعوا خطوات كُتّابها.
غير أن هذا الفن الحديث النشأة بدأ تدريجياً يجد أساليبه الخاصة في التعبير الشائق لرواد السينما الجدد. لعل أهم شيء اكتشفه أولئك السينمائيون الأوائل أن البصر الذي هو حلقة الوصل بين الفيلم والإدراك سريع الملل، فالصورة كي تُدرك ذهنياً بحاجة إلى أن تتحول إلى فكرة، وهذه الفكرة تدور في رأس المتلقي بالكلمات، بينما الحال مقلوبة مع الرواية؛ فالجملة المقروءة التي تشبه إطاراً واحداً من فيلم تتحول مع جمل مجاورة أخرى إلى صورة في العقل قبل استيعاب الرسالة التي تتضمنها. لذلك؛ فإن الرواية المقروءة قادرة على التعبير عن أفكار وتتحرك بين أزمنة الماضي والحاضر، في حين أن العين تتعقب حركة الزمن المتحرك إلى أمام.
مع بدء السينما الناطقة في أوائل الثلاثينات ونشوء «هوليوود» تطورت الأدوات التي يستخدمها مخرجو الأفلام مع بروز حرف جديدة مثل كتابة السيناريو، وتأليف الموسيقى التصويرية الملازمة للفيلم لتعميق الحالة الشعورية التي يتركها هذا المشهد أو ذاك في نفس المُشاهد، وخلق سرد موسيقي متجاور مع سلسلة أحداث الفيلم، بحيث يكون الأول متماشياً مع الحالة العاطفية التي يريد المخرج السينمائي أن ينقلها فيلمه على امتداد شريطه.
حتى ذلك الوقت ظلت الرواية قادرة على جذب القراء مستثمرة تلك الفجوة في طريقة التلقي المختلفة تماماً عن الفيلم.
في هذه المرحلة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ اعتماد السينما على الروايات يتقلص، وهذا مع بروز كتّاب سيناريو مؤهلين كي يقدموا مخطوطات عامة (غير أدبية) تتكون من مشاهد مرقمة يستطيع المخرجون أن يغيروا بعضها أو يطلبوا من كتابها إضافة أو حذف هذا المشهد أو ذاك. كذلك أصبح هناك إنتاج موسيقي خالص خاص بكل فيلم وأصبحت الموسيقى التصويرية جزءاً من هوية الفيلم المعني. إضافة إلى ذلك تطورت حرفة المونتير الذي يقوم بإزالة كل جزء غير ضروري من الفيلم قبل عرضه بحيث يجعله شبيهاً بسيمفونية لا تحتمل أي زيادة تجدها الأذن نشازاً حتى ولو لوقت قصير جداً، في الوقت نفسه يقوم المونتير بضمان أن العين أداة التلقي الأولية للصورة لا تشعر بالملل حالها حال الأذن مع الموسيقى التصويرية.
حتى نهاية القرن العشرين ظل للرواية المطبوعة ورقياً قراؤها الواسعون الذين هم في الوقت نفسه مشدودون إلى السينما الجادة.
ولعل وقت الفراغ ظل كافياً لاحتواء هذين الصنوين: الرواية والفيلم الروائي (feature film)، فالتنقل بين البيت ومكان العمل ذهاباً وإياباً يتطلب في الغالب استخدام وسائل نقل عامة مثل قطارات الأنفاق أو الحافلات، يشجع على قراءة الروايات للاستمتاع بهذا الوقت الذي يمتد عادة لأكثر من ساعتين، ناهيك من ملازمة القراءة على شواطئ البحار خلال العطلات السنوية، أما مشاهدة الأفلام سواء أكانت في قاعات السينما أو باستخدام أقراص الفيديو (التي انتشرت محلات تأجيرها في الكثير من المناطق داخل أي مدينة) فقد تضاءلت لصالح المنصات. غير أن هذا التوازن في اقتسام الوقت كُسِر مع بداية القرن الحادي والعشرين واتساع سريع لرقعة استخدام الجوالات الذكية، ومعها اتسعت جملة تطبيقات راحت تتسلل إليها أو إلى الحواسيب. وكلها راحت تتنافس مع الرواية المكتوبة سواء أكانت بصيغة ورقية أو رقمية (إلكترونية).
كانت فكرة ستيف جوبز مدير شركة «أبل» أشبه بضربة قاضية لعدد كبير من الصناعات التي ظلت قائمة خلال أكثر عقود القرن العشرين؛ مثل الكاميرات وأدوات التسجيل، وفي الوقت نفسه شجع إنتاج الجوالات القادرة على استيعاب عدد متزايد من التطبيقات مثل ألعاب الفيديو و«يوتيوب» الذي أتاح عدداً هائلاً من الإمكانيات لاستخدام الصورة والصوت بدلاً من القراءة، على تقديم برامج مبسطة قصيرة الأمد عن كل ما ظلت الكتب الفلسفية والعلمية تحاول تقديمه بشكل معمق وتفصيلي. بل حتى الروايات المقروءة بأصوات جذابة أصبحت تحل تدريجياً محل تلك المطبوعة.
هذا الاتساع الهائل في التطبيقات مع تطبيق «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«واتساب» و«يوتيوب» كان على حساب الوقت المخصص للقراءة بشكل عام وخصوصاً قراءة الروايات والقصص.
ومع دخول وسائل إمتاع أخرى هدفها تنشيط الذاكرة وقتل الملل أصبحت ألعاب الفيديو وتبادل الأخبار والآراء مع وسط أوسع بكثير من دائرة الأقارب والأصدقاء، ما جعل الشباب الذين ولدوا مع بداية ثورة الاتصالات أكثر استغراقاً في هذا العالم الافتراضي الذي تعكسه شاشات جوالاتهم والألواح الذكية من ألعاب فيديو إلى مواقع غير محدودة تغطي الكثير من الموضوعات التي تجذبهم، كلٌّ وفق اهتمامه. ولعلي لا أغالي إذا قلت إنهم مقتنعون بوجودها منذ الأزل. لقد شجعت الجوالات والألواح الذكية ظهور تطبيقات أدت إلى تقليص الانجذاب إلى وسائل اللهو خارج البيت، فحل موقع «نتفليكس» محل قاعات السينما إلى حد كبير، ما أدى إلى تقلصها كثيراً في المدن الكبرى مثل لندن وباريس.
مع ذلك، فإن الفيلم الروائي ظل حتى يومنا هذا نقطة جذب إلى جانب اتساع الاهتمام بالفيلم الوثائقي.
ما مصير الرواية مع تقلص الوقت المتوافر لقراءتها أمام كل هذه التطبيقات المغرية التي ترضي قدراً كبيراً من الغرور الشخصي وحب الظهور، فضلاً عن قدرتها على تقديم أشكال كثيرة ومتزايدة من الإمتاع؟
تظل أسئلة كثيرة ما زال علماء النفس واللغويون لم يقدموا إجابات عنها: ما الفرق بين قراءة الرواية المطبوعة والاستماع إليها؛ أي تسلمها عبر البصر أو السمع؟ وماذا يعني هذا التشتت الذهني الهائل للشباب بين مواقع وتطبيقات تتزايد يوماً بعد يوم على درجة التركيز التي تتطلبها قراءة الرواية؟ وما مصيرها على الأمد الأبعد ككتاب مطبوع ورقياً أو رقمياً؟
هل سيكون مكانها المتحف إلى جانب ما أبدعه الإنسان من أثريات قيّمة خلال رحلته في الزمن منذ ابتكاره الكتابة والقراءة؟